أين تهدأ رحلتي؟
3 أكتوبر 2020
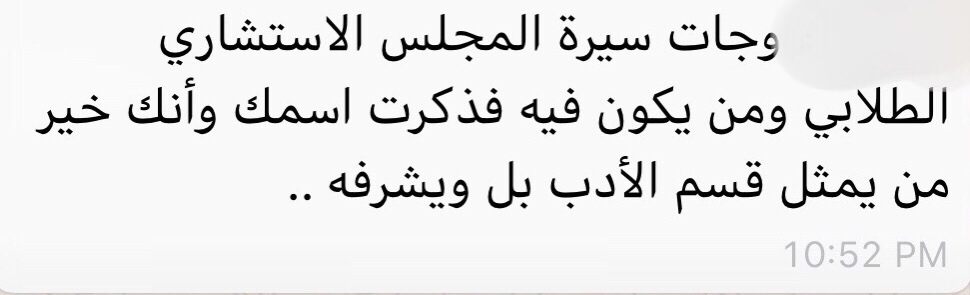 لطالما بحثتُ عن الحق وكنتُ صوتًا للصامتين، أتحدث حين يصمت الجميع، وأقف حين يقعد الجميع. أدافع عمّن لا يستطيع الدفاع عن أنفسه، عمّن تخونه الكلمات. أولئك الذين لا يسمعهم أحد، ولطالما يسخرون بي بقولهم: "مين حطك محامية لهم؟" بَدا للجملة صدى في مسمعي فأحببتها، ما أجملها من فكرة! أن أُحامي عن أحد... كانت مديرة مدرستي حين تراني مُقبلة تُرحب بي قائلة: "هلا بالمحامية سارة" وفي الطابور الصباحي تُلقي التحيّة بعد أن تُطوّقها بـ"المحامية" وحين تحدث مشكلة في الفصلِ تطلب منّي الحضور، تعلم دائمًا بأني سأقول الحقّ، ويُصيبني الذعر من أن تقعن صديقاتي في قبضتها فأكون بين نارين.
كنتُ أشعر بأني مسؤولة عن الآخرين -وما زلت- فمنذُ ذلك الوقت، وكلّما رأيتُ الحزن يكسو ملامح الصامتون؛ تراءت لي تلك الجملة. أفعل كل شيء؛ لأرى بريق أعينهم عند نُطقي بما يعجزون عن قوله. شعرتُ بأني أخفف حزنهم، أو ربما هذا ما بَدا لي -لولعي الشديد بالمحاماة- ومن هذه الناحية لم يكن الجواب على سؤال "ماذا ستتخصصين في الجامعة؟" صعبًا بطبيعة الحال. فأول ما بدر في ذهني تخصص (القانون) نعم! أجد نفسي هناك، وسأكون كما أردت دائمًا؛ إجابة دعاء المظلومين، والمستضعفين... تؤرقني فكرة انتصار الظالم على المظلوم لفترةٍ من الزمن، فكرة أن هناك من هو مظلوم في مكانٍ لا يعرفه أحد، لا يسمعه أحد، لا يبالي به أحد... لا سيما المقبوعين في السجون ظُلمًا! قد عاشت، وكبرت معي هذه الإجابة من ثاني متوسط إلى أول سنة جامعيّة. يا لها من مُدّة! أليس كذلك؟
ومن الناحية الأخرى؛ أجوبُ عالم الأدب، بين أبيات الشِّعر، أغترف من نهر العربيّة معانٍ بليغة، وأفكار بديعة، وتشبيهات جماليّة، ولا أرتوي. وأهوى الحديث بالفصحى، ولا أكتفي. وقد كانوا يسخرون بي أيضًا عند تحدثي بها، فتهتف إحداهن قائلة: "تكلمي عربي!" فأضحكُ مِلء شدقيّ، ودائمًا ما كنت أترقّب حصة الأدب العربي، حيث أقف مع امرؤ القيس ونبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ، وحين تذكرّتُ مع ابن زيدون بالزهراء مشتاقًا -لم يكن حينها الأفق طلقًا- لكن ما الشِّعر إن لم يُحلّق بروحك عن الأرض التي تقف عليها؟ تُلقي الأستاذة بيتان من الشعر فأُبحر في تحليلهما، وتصوير مشهد مسرحي... إلى أن تتمايل عليَّ صديقتي هَضيمَ الكَشحِ بهدوء؛ لتهمس لي أن الأستاذة ترمقني بصمتٍ ظنًّا منها بأن الهواجس تهيمُ في صدري، ولستُ معهم، لا تدري بأن هذا كله؛ لأني معهم. عمومًا، كان يفعل بي الشعر مالا يفعله أحد... وحيث تُشبع الأستاذة شغفي بالكتابة، وتكلفنا بكتابة قصةٍ من وحي الخيال، فيظل يرتمين البنات بأوراقهن لأكتب لهن، وأكتب للجميع من خيالي -بكلِّ حُبٍّ- وأعتذر للأستاذة التي بَدَا لها بأن الجميع يتوق للكتابة فكُنتُ أنا.
ورغم خيالي الواسع للغاية، لم أتخيّل في يومٍ بأني سأتخصص في الجامعة (كليّة اللغة العربيّة - قسم الأدب) يا إلهـي! أحلامي، وطموحي، ونفسي -التي ظننت بأني وجدتها-؛ فُقدوا جميعًا في تلك اللحظة! صُعقت عند ظهور النتائج، أدرت الشاشة لوالدتي كي تقرأ فربما عيني مليئة بالدموعِ، ولم أرَ جيدًا! ضاقت علي الأرض بما رحبت، وظننتُ بأنها نهاية العالم. لم أغضب لقبولي بهذا التخصص-بحكم حبّي له، وشغفي به-؛ بل على درجتي العالية التي هُلكت حتى نلتها، ورحيل حلمي الذي أحببته. كيف لأحلامنا أن تتخلى عنّا بهذي السهولة؟ كيف سأنتصر للمظلومين، ولم أنتصر لنفسي؟ آرقتني الأسئلة...
"لا تخافين، تقدرين تحولين بيفتح قريب"
سماعي لتلك الجملة مدّني بالصبر طوال الفصل الدراسي الأول، حيث يمضي الوقت بطيئًا، والأيام ثِقال مسربلة بالكآبة، أجوبُ بين وحشة الأزقّة، وأحمل حلمي كحقيبة ظهر، ويهتف من حولي قائلين: "لا تَهلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ...."
لكنني كنتُ حين أدخل القاعة الدراسيّة، أشعر بأني دخلتُ منزلي، أصيرُ كطيرٍ ثقيلٌ عليه المشي بقدميه، وخفيفٌ بطبيعته، وهو التحليق بجناحيه في الأُفقِ دون ثُقل يحمله! هكذا أكون، أنسى كل ثقل يحمله قلبي، وكل فكرة أرقت مضجعي، وحلمي الذي أحببته، ورغم استمتاعي في المحاضرات كنت أكابر، وأخفي الحقيقة، ولا أبوح بها لأحد، حتى نفسي... فحين أرفع يدي التي تكاد تصل السقف لشِدّة حماسي للمشاركة، أُدرك ذلك بسرعة وأُنزلها بهدوء تام؛ لئلا ألاحظ ذلك، خشيةً أن أتوقف عن المحاولة...
"فتح التقديم لطلبات التحويل"
سعدتُ أيما سعادة! هرعت أصابعي تجري للموقع، وكأن شيئًا ما يُلاحقها! قدّمتُ طلبًا، وطال انتظاري إلى إجازة منتصف العام. ظهرت النتائج؛ وقُوبل طلبي بالرفض، وكانت تلك الصعقة الثانية. ولكنّها لم توقفنِ؛"فما زلتُ ألمح في رماد العمر شيئًا من أمل" ولعل أعلى مراحل اليأس أن تفتش عن الأمل. أكملت، وفي نهاية الفصل الدراسيّ الثاني فتح التقديم، وقدّمت طلبًا للمرة الثالثة، وظهرت نتائجه؛ وقُوبل بالرفض، وقلت لنفسي:"حسنًا على الأقل أنا الآن في إجازة" الأمر أشبه بأن أضع بنفسي لنفسي أبرة مُهدئ.
وفي نهاية الإجازة، وقبل أن تبدأ السنة الدراسية الثانية قررتُ النأي بروحي عن كل هذا التخبط، وأجلت دراسة فصل، وتقديم طلب تحويل -والحمد لله أني فعلت- فرغم تراكم الساعات الدراسيّة، وتأخري في دراسة بعض المستويات، وربما سأتأخر في تخرجي إلا أني مُمتنّة لذلك القرار. ففيها قد اقتربتُ من نفسي أكثر من ذي قبل، وأبصرتُ من أمري ما لم أبصره من قبل، وكشفتُ عمّا كان مُغلّف بغشاء، واعتذرت عن استعجالي في الإجابة، وتصديق الوهم الذي عشته وأحببته، والحقيقة التي لم أقبل بمواجهتها، وسامحتني بعدما تقبلتها كما هي. وسرُّ وجود نفسك لا يجيء بأدلة تثبت ذلك، بل بشعور منبثق داخلك عميق، يجب عليك الغرق مرارًا وتكرارًا؛ حتى تصل إليه، وربما ستظن كثيرًا بأنك وصلت، لكنك لم تصل، المهم أن تعرف قيمة نفسك، وما تفعله.
فزعتُ إلى الله من كل سؤال أرقني، ومن كل خوف، وقلق فاستخرت العليم، القدير، اللطيف، الخبير، بين تخصص الأدب، والقانون.. وعليه توكلتُ، ومضيتُ أقضي الإجازة في مواجهة الحقائق، عمّا فات وعمّا هو آتٍ، وكيف أكون ما أريده حتى إن لم أُقبل بما يساعدني في تحقيقه؟ قلّبت النظر فيما حولي، وأدركت بعض الأمور، وكثيرًا ما كنت أبحث، ولم أجدنِ من أول جواب -وربما إلى الآن- لكنني على الأقل عرفتُ نفسي، وقيمتها. فكما قال المنفلوطي:"حسبُك من الذكاء أن تعرفَ قيمةَ نفسك" خضتُ الإجازة باحثةً في المجالات، والتساؤلات، وماذا يريد الله اخباري؟ وما الذي يريدني أن أكونه؟ وما الذي أستمتع حقًّا بفعله/ دراسته؟ طوّرتُ لُغتي الإنجليزية، وحضرت دورات عن لغة الجسد، وتعلمت بضعة حروف من لغة الإشارة، -وذلك أمرٌ مُضحك- حيث أنني هربت من اللغة إلى اللغة. جعلت أجوب بين طيّات الكتب، ووجدت بعض الأجوبة في السطور، واللغات، والتجارب، وبعضها ما زلت أجهلها. وأهم ما خرجتُ به هو أن كل إنسان على هذه الأرض يستحق أن يمنح نفسه فرصة للبحث عنها، ومعرفة قيمتها. فبعدها ستبحث ما حييت، وفي كل مرةٍ تعتقد فيها بأنك وجدت نفسك؛ تلوح لك تساؤلات، وتخوض تجارب؛ فتكتشف نفسك أكثر، وتبحث أكثر، وهذه الفكرة جزء مهم من رحلتنا في الحياة.
انتهت الإجازة فبدأ الفصل الثاني، وقررت استغلال آخر فرصة لي. أعترف بأني مهووسة باستغلال الفرص، وفعل ما يقع على عاتقي. خفتُ أن يعذبني ضميري فيلاحقني طوال حياتي. خشيت أن تكون الفرصة الناجحة هي الأخيرة! فأكملتُ الدراسة في الأدب، وقدمتُ طلب تحويل في نفس الوقت، وظهرت نتيجة الطلب بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، وقُوبل بالرفض، لكنني لم أُصعق هذه المرة؛ بل شيئًا ما في نفسي قد تغيّر! شيئًا ما قد دق أجراس الفرح! شيئًا ما قد باح لنفسه، والعالم أجمع أنه سيكمل برغبته، ومحبته دراسة هذا التخصص. بشّرتُ عائلتي وصَحبي بأني عرفتُ أين تهدأ رحلتي، والأرضُ التي تستريح فيها ركابي... وأدركتُ أن باستطاعتي الانتصار للمظلومين لو بكلمة، كنتُ هكذا قبل أن أضع القانون أول رغبة لي، فكيف سأجعل عدم قبولي به يسلب هذا مني؟ ما زلتُ أستطيع التحدث حين يصمت الجميع، والوقوف حين يقعد الجميع!
بدأتْ السنة الدراسيّة الثانية، ووطأتْ قدمي مبنى اللغة العربيّة، وكما ترمز له الجامعة "مبنى دال" والحمد لله بأن دليتُ طريقه! كنتُ كمن عاد إلى منزله... استقرت الطمأنينة في قلبي، وشعرتُ بإنتماء مُسبق.. لم يرَ أحد كيف تسلل النور إلى روحي، أدركتُ حينها بأن طموحي، وأحلامي التي ظننتُ بأني فقدتهم كانوا بالقرب منّي، وأنا من كنت بعيدة، بعيدة جدًّا! استغرقتُ الكثير من الوقت كي أدرك بأني قد انتصرت لنفسي.. لكنني الآن في مكاني المناسب، وسعيدة بذلك للغاية.
ومن لا يشكر الناس؛ لا يشكر الله! فبعد توفيقه وفضله، أحاطني بأستاذاتٍ شغوفات بما يقدّمن، حريصاتٌ على العلم، مهذبات، خلوقات.. مهدن لي الطريق، وكانن لي خير عون بعد الله! مثّلن لي تخصص الأدب بأخلاقهن، وحسن تعاملهن، وجمال طباعهن، وعذوبة شرحهن بالألفاظ المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان، وهكذا يكون الأدب صفةً، لا تخصص فحسب! ولطالما جذبني رؤية ما فعلته اللغة، والأدب بهنّ بلا تكلّف أو تصنّع؛ بل سجية! ولم يكُن مجرد تخصصٌ أدرسه فحسب؛ بل حياة أخوضها على درايةٍ بأني لن أكون نفس الشخص الذي دخلها... جمع لي كلّ الأحبّة؛ الدين، والشعر، والتاريخ، والفلسفة.. وإن هذا الفوز لعمري!
ربِّي .. هذبتني لغتك.. قوّمني النحو.. تذوّقتُ الأدب.. سحرني البيان.. أدهشتني البلاغة.. منحتني اللغة رؤية الأمور بصورةٍ مختلفة، ومن زوايا عديدة، وسّعت مدارك الفكر، والجمال في آنٍ واحد.. عَلَّمتني كيف يكون الاختلاف في أبسط الأشياء فارق، والحديث بوعيٍ أكثر.. رققت القلب، وهذبت الطباع.. عَلَّمتني أن اللغة أكبر من أن تكون مجرد إعراب تعلمناه في المدرسة! فكما يقول محمد درويش: "أنا لغتي" اللغة أنا، اللغة أنت، اللغة نحن...
شكرًا لك ربِّي لأنك وضعتني هنا، وعرفتني أكثر من نفسي، شكرًا لأنك منحتني فرصة لاكتشاف هذا العلم، شكرًا لأنك عاملتني بما أنتَ أهلٌ له. الحمد لله على هذه الفرصة، وخوض تلك الصعاب، على اختيارك، وفضلك ولطفك، ورحمتك. ووجودك معي، في كل مرةٍ ظننت فيها بأنِّي وحدي. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأنها النهاية، وأنقذتني. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأن الأبواب أُغلقت، وفتحت لي بابك. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأني أضعتني، ودليتني على الطريق. وأعتذر يا الله عن كل مرةٍ بكيت فيها سخطًا. أعتذر عن كل مرة قلت فيها بيني وبين نفسي: "لماذا لا يستجيب الله لي" أعتذر ربِّي فبمحدودية بصيرتي في ذلك الوقت لم أُدرك بأنك استجبت لي الخير كلّه في قدري الذي اخترته لي... رأيتُ بأم عيني ما كان يقصده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قال: "لو عُرضت الأقدار على الإنسان، لأختار القدر الذي اختاره الله له"
وفي نهاية الأمر أقول:
لكل أولئك المُقبلين على المرحلة الجامعيّة، الذين يسكن قلوبهم القلق، والخوف من الدخول لمرحلةٍ جديدة: ثقوا في الله الذي يعرفنا حقّ المعرفة، الذي يضعنا في المكان الذي نستحقه ولو بعد حين، الذي يعرف نقاط ضعفنا، وقوتنا أكثر من أنفسنا، واكتشفوا أنفسكم، ولا تُلهيكم التوافه، والمُغريات عن أنفسكم، وحقيقة وجودنا على هذه الأرض. حاولوا كثيرًا ولا تستسلموا؛ فقد يكون القبول في تخصصٍ ما طريقًا أراد الله لكم عبوره كي تصلون لتخصصٍ آخر -لحكمةٍ بالغة- وتقبّلوا الأمور التي فُرضت عليكم، وتعايشوا معها سيُصبح مرورها أسهل بكثير، فغالبًا تكون مشكلتنا ليست في الأمور التي فُرضت علينا؛ بل في رفض تقبّلها والتعايش معها. عدم تقبّلك لن يُفيدك، ويُغيّر شيئًا إن لم يكن بيدك حيلة؛ فاستمتعوا ما دمتم مُجبرون.
• أسأل الله قرة أعين السائلين.. أن يجود عليكم بكرمه، ورحمته طمأنينةٍ تستقرّ في قلوبكم لا يبدّلها قلق، ولا يؤرقها هم، وأن تُرفرف أجنحتكم في سماءِ أحلامكم، ويكتب لكم الخير حيثما كان ثم يرضيكم به، إنَّك سميع الدعاء.
لطالما بحثتُ عن الحق وكنتُ صوتًا للصامتين، أتحدث حين يصمت الجميع، وأقف حين يقعد الجميع. أدافع عمّن لا يستطيع الدفاع عن أنفسه، عمّن تخونه الكلمات. أولئك الذين لا يسمعهم أحد، ولطالما يسخرون بي بقولهم: "مين حطك محامية لهم؟" بَدا للجملة صدى في مسمعي فأحببتها، ما أجملها من فكرة! أن أُحامي عن أحد... كانت مديرة مدرستي حين تراني مُقبلة تُرحب بي قائلة: "هلا بالمحامية سارة" وفي الطابور الصباحي تُلقي التحيّة بعد أن تُطوّقها بـ"المحامية" وحين تحدث مشكلة في الفصلِ تطلب منّي الحضور، تعلم دائمًا بأني سأقول الحقّ، ويُصيبني الذعر من أن تقعن صديقاتي في قبضتها فأكون بين نارين.
كنتُ أشعر بأني مسؤولة عن الآخرين -وما زلت- فمنذُ ذلك الوقت، وكلّما رأيتُ الحزن يكسو ملامح الصامتون؛ تراءت لي تلك الجملة. أفعل كل شيء؛ لأرى بريق أعينهم عند نُطقي بما يعجزون عن قوله. شعرتُ بأني أخفف حزنهم، أو ربما هذا ما بَدا لي -لولعي الشديد بالمحاماة- ومن هذه الناحية لم يكن الجواب على سؤال "ماذا ستتخصصين في الجامعة؟" صعبًا بطبيعة الحال. فأول ما بدر في ذهني تخصص (القانون) نعم! أجد نفسي هناك، وسأكون كما أردت دائمًا؛ إجابة دعاء المظلومين، والمستضعفين... تؤرقني فكرة انتصار الظالم على المظلوم لفترةٍ من الزمن، فكرة أن هناك من هو مظلوم في مكانٍ لا يعرفه أحد، لا يسمعه أحد، لا يبالي به أحد... لا سيما المقبوعين في السجون ظُلمًا! قد عاشت، وكبرت معي هذه الإجابة من ثاني متوسط إلى أول سنة جامعيّة. يا لها من مُدّة! أليس كذلك؟
ومن الناحية الأخرى؛ أجوبُ عالم الأدب، بين أبيات الشِّعر، أغترف من نهر العربيّة معانٍ بليغة، وأفكار بديعة، وتشبيهات جماليّة، ولا أرتوي. وأهوى الحديث بالفصحى، ولا أكتفي. وقد كانوا يسخرون بي أيضًا عند تحدثي بها، فتهتف إحداهن قائلة: "تكلمي عربي!" فأضحكُ مِلء شدقيّ، ودائمًا ما كنت أترقّب حصة الأدب العربي، حيث أقف مع امرؤ القيس ونبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ، وحين تذكرّتُ مع ابن زيدون بالزهراء مشتاقًا -لم يكن حينها الأفق طلقًا- لكن ما الشِّعر إن لم يُحلّق بروحك عن الأرض التي تقف عليها؟ تُلقي الأستاذة بيتان من الشعر فأُبحر في تحليلهما، وتصوير مشهد مسرحي... إلى أن تتمايل عليَّ صديقتي هَضيمَ الكَشحِ بهدوء؛ لتهمس لي أن الأستاذة ترمقني بصمتٍ ظنًّا منها بأن الهواجس تهيمُ في صدري، ولستُ معهم، لا تدري بأن هذا كله؛ لأني معهم. عمومًا، كان يفعل بي الشعر مالا يفعله أحد... وحيث تُشبع الأستاذة شغفي بالكتابة، وتكلفنا بكتابة قصةٍ من وحي الخيال، فيظل يرتمين البنات بأوراقهن لأكتب لهن، وأكتب للجميع من خيالي -بكلِّ حُبٍّ- وأعتذر للأستاذة التي بَدَا لها بأن الجميع يتوق للكتابة فكُنتُ أنا.
ورغم خيالي الواسع للغاية، لم أتخيّل في يومٍ بأني سأتخصص في الجامعة (كليّة اللغة العربيّة - قسم الأدب) يا إلهـي! أحلامي، وطموحي، ونفسي -التي ظننت بأني وجدتها-؛ فُقدوا جميعًا في تلك اللحظة! صُعقت عند ظهور النتائج، أدرت الشاشة لوالدتي كي تقرأ فربما عيني مليئة بالدموعِ، ولم أرَ جيدًا! ضاقت علي الأرض بما رحبت، وظننتُ بأنها نهاية العالم. لم أغضب لقبولي بهذا التخصص-بحكم حبّي له، وشغفي به-؛ بل على درجتي العالية التي هُلكت حتى نلتها، ورحيل حلمي الذي أحببته. كيف لأحلامنا أن تتخلى عنّا بهذي السهولة؟ كيف سأنتصر للمظلومين، ولم أنتصر لنفسي؟ آرقتني الأسئلة...
"لا تخافين، تقدرين تحولين بيفتح قريب"
سماعي لتلك الجملة مدّني بالصبر طوال الفصل الدراسي الأول، حيث يمضي الوقت بطيئًا، والأيام ثِقال مسربلة بالكآبة، أجوبُ بين وحشة الأزقّة، وأحمل حلمي كحقيبة ظهر، ويهتف من حولي قائلين: "لا تَهلِكْ أَسًى وَتَجَمَّلِ...."
لكنني كنتُ حين أدخل القاعة الدراسيّة، أشعر بأني دخلتُ منزلي، أصيرُ كطيرٍ ثقيلٌ عليه المشي بقدميه، وخفيفٌ بطبيعته، وهو التحليق بجناحيه في الأُفقِ دون ثُقل يحمله! هكذا أكون، أنسى كل ثقل يحمله قلبي، وكل فكرة أرقت مضجعي، وحلمي الذي أحببته، ورغم استمتاعي في المحاضرات كنت أكابر، وأخفي الحقيقة، ولا أبوح بها لأحد، حتى نفسي... فحين أرفع يدي التي تكاد تصل السقف لشِدّة حماسي للمشاركة، أُدرك ذلك بسرعة وأُنزلها بهدوء تام؛ لئلا ألاحظ ذلك، خشيةً أن أتوقف عن المحاولة...
"فتح التقديم لطلبات التحويل"
سعدتُ أيما سعادة! هرعت أصابعي تجري للموقع، وكأن شيئًا ما يُلاحقها! قدّمتُ طلبًا، وطال انتظاري إلى إجازة منتصف العام. ظهرت النتائج؛ وقُوبل طلبي بالرفض، وكانت تلك الصعقة الثانية. ولكنّها لم توقفنِ؛"فما زلتُ ألمح في رماد العمر شيئًا من أمل" ولعل أعلى مراحل اليأس أن تفتش عن الأمل. أكملت، وفي نهاية الفصل الدراسيّ الثاني فتح التقديم، وقدّمت طلبًا للمرة الثالثة، وظهرت نتائجه؛ وقُوبل بالرفض، وقلت لنفسي:"حسنًا على الأقل أنا الآن في إجازة" الأمر أشبه بأن أضع بنفسي لنفسي أبرة مُهدئ.
وفي نهاية الإجازة، وقبل أن تبدأ السنة الدراسية الثانية قررتُ النأي بروحي عن كل هذا التخبط، وأجلت دراسة فصل، وتقديم طلب تحويل -والحمد لله أني فعلت- فرغم تراكم الساعات الدراسيّة، وتأخري في دراسة بعض المستويات، وربما سأتأخر في تخرجي إلا أني مُمتنّة لذلك القرار. ففيها قد اقتربتُ من نفسي أكثر من ذي قبل، وأبصرتُ من أمري ما لم أبصره من قبل، وكشفتُ عمّا كان مُغلّف بغشاء، واعتذرت عن استعجالي في الإجابة، وتصديق الوهم الذي عشته وأحببته، والحقيقة التي لم أقبل بمواجهتها، وسامحتني بعدما تقبلتها كما هي. وسرُّ وجود نفسك لا يجيء بأدلة تثبت ذلك، بل بشعور منبثق داخلك عميق، يجب عليك الغرق مرارًا وتكرارًا؛ حتى تصل إليه، وربما ستظن كثيرًا بأنك وصلت، لكنك لم تصل، المهم أن تعرف قيمة نفسك، وما تفعله.
فزعتُ إلى الله من كل سؤال أرقني، ومن كل خوف، وقلق فاستخرت العليم، القدير، اللطيف، الخبير، بين تخصص الأدب، والقانون.. وعليه توكلتُ، ومضيتُ أقضي الإجازة في مواجهة الحقائق، عمّا فات وعمّا هو آتٍ، وكيف أكون ما أريده حتى إن لم أُقبل بما يساعدني في تحقيقه؟ قلّبت النظر فيما حولي، وأدركت بعض الأمور، وكثيرًا ما كنت أبحث، ولم أجدنِ من أول جواب -وربما إلى الآن- لكنني على الأقل عرفتُ نفسي، وقيمتها. فكما قال المنفلوطي:"حسبُك من الذكاء أن تعرفَ قيمةَ نفسك" خضتُ الإجازة باحثةً في المجالات، والتساؤلات، وماذا يريد الله اخباري؟ وما الذي يريدني أن أكونه؟ وما الذي أستمتع حقًّا بفعله/ دراسته؟ طوّرتُ لُغتي الإنجليزية، وحضرت دورات عن لغة الجسد، وتعلمت بضعة حروف من لغة الإشارة، -وذلك أمرٌ مُضحك- حيث أنني هربت من اللغة إلى اللغة. جعلت أجوب بين طيّات الكتب، ووجدت بعض الأجوبة في السطور، واللغات، والتجارب، وبعضها ما زلت أجهلها. وأهم ما خرجتُ به هو أن كل إنسان على هذه الأرض يستحق أن يمنح نفسه فرصة للبحث عنها، ومعرفة قيمتها. فبعدها ستبحث ما حييت، وفي كل مرةٍ تعتقد فيها بأنك وجدت نفسك؛ تلوح لك تساؤلات، وتخوض تجارب؛ فتكتشف نفسك أكثر، وتبحث أكثر، وهذه الفكرة جزء مهم من رحلتنا في الحياة.
انتهت الإجازة فبدأ الفصل الثاني، وقررت استغلال آخر فرصة لي. أعترف بأني مهووسة باستغلال الفرص، وفعل ما يقع على عاتقي. خفتُ أن يعذبني ضميري فيلاحقني طوال حياتي. خشيت أن تكون الفرصة الناجحة هي الأخيرة! فأكملتُ الدراسة في الأدب، وقدمتُ طلب تحويل في نفس الوقت، وظهرت نتيجة الطلب بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، وقُوبل بالرفض، لكنني لم أُصعق هذه المرة؛ بل شيئًا ما في نفسي قد تغيّر! شيئًا ما قد دق أجراس الفرح! شيئًا ما قد باح لنفسه، والعالم أجمع أنه سيكمل برغبته، ومحبته دراسة هذا التخصص. بشّرتُ عائلتي وصَحبي بأني عرفتُ أين تهدأ رحلتي، والأرضُ التي تستريح فيها ركابي... وأدركتُ أن باستطاعتي الانتصار للمظلومين لو بكلمة، كنتُ هكذا قبل أن أضع القانون أول رغبة لي، فكيف سأجعل عدم قبولي به يسلب هذا مني؟ ما زلتُ أستطيع التحدث حين يصمت الجميع، والوقوف حين يقعد الجميع!
بدأتْ السنة الدراسيّة الثانية، ووطأتْ قدمي مبنى اللغة العربيّة، وكما ترمز له الجامعة "مبنى دال" والحمد لله بأن دليتُ طريقه! كنتُ كمن عاد إلى منزله... استقرت الطمأنينة في قلبي، وشعرتُ بإنتماء مُسبق.. لم يرَ أحد كيف تسلل النور إلى روحي، أدركتُ حينها بأن طموحي، وأحلامي التي ظننتُ بأني فقدتهم كانوا بالقرب منّي، وأنا من كنت بعيدة، بعيدة جدًّا! استغرقتُ الكثير من الوقت كي أدرك بأني قد انتصرت لنفسي.. لكنني الآن في مكاني المناسب، وسعيدة بذلك للغاية.
ومن لا يشكر الناس؛ لا يشكر الله! فبعد توفيقه وفضله، أحاطني بأستاذاتٍ شغوفات بما يقدّمن، حريصاتٌ على العلم، مهذبات، خلوقات.. مهدن لي الطريق، وكانن لي خير عون بعد الله! مثّلن لي تخصص الأدب بأخلاقهن، وحسن تعاملهن، وجمال طباعهن، وعذوبة شرحهن بالألفاظ المستحسنة في الآذان، المقبولة عند الأذهان، وهكذا يكون الأدب صفةً، لا تخصص فحسب! ولطالما جذبني رؤية ما فعلته اللغة، والأدب بهنّ بلا تكلّف أو تصنّع؛ بل سجية! ولم يكُن مجرد تخصصٌ أدرسه فحسب؛ بل حياة أخوضها على درايةٍ بأني لن أكون نفس الشخص الذي دخلها... جمع لي كلّ الأحبّة؛ الدين، والشعر، والتاريخ، والفلسفة.. وإن هذا الفوز لعمري!
ربِّي .. هذبتني لغتك.. قوّمني النحو.. تذوّقتُ الأدب.. سحرني البيان.. أدهشتني البلاغة.. منحتني اللغة رؤية الأمور بصورةٍ مختلفة، ومن زوايا عديدة، وسّعت مدارك الفكر، والجمال في آنٍ واحد.. عَلَّمتني كيف يكون الاختلاف في أبسط الأشياء فارق، والحديث بوعيٍ أكثر.. رققت القلب، وهذبت الطباع.. عَلَّمتني أن اللغة أكبر من أن تكون مجرد إعراب تعلمناه في المدرسة! فكما يقول محمد درويش: "أنا لغتي" اللغة أنا، اللغة أنت، اللغة نحن...
شكرًا لك ربِّي لأنك وضعتني هنا، وعرفتني أكثر من نفسي، شكرًا لأنك منحتني فرصة لاكتشاف هذا العلم، شكرًا لأنك عاملتني بما أنتَ أهلٌ له. الحمد لله على هذه الفرصة، وخوض تلك الصعاب، على اختيارك، وفضلك ولطفك، ورحمتك. ووجودك معي، في كل مرةٍ ظننت فيها بأنِّي وحدي. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأنها النهاية، وأنقذتني. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأن الأبواب أُغلقت، وفتحت لي بابك. وفي كل مرةٍ ظننت فيها بأني أضعتني، ودليتني على الطريق. وأعتذر يا الله عن كل مرةٍ بكيت فيها سخطًا. أعتذر عن كل مرة قلت فيها بيني وبين نفسي: "لماذا لا يستجيب الله لي" أعتذر ربِّي فبمحدودية بصيرتي في ذلك الوقت لم أُدرك بأنك استجبت لي الخير كلّه في قدري الذي اخترته لي... رأيتُ بأم عيني ما كان يقصده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حين قال: "لو عُرضت الأقدار على الإنسان، لأختار القدر الذي اختاره الله له"
وفي نهاية الأمر أقول:
لكل أولئك المُقبلين على المرحلة الجامعيّة، الذين يسكن قلوبهم القلق، والخوف من الدخول لمرحلةٍ جديدة: ثقوا في الله الذي يعرفنا حقّ المعرفة، الذي يضعنا في المكان الذي نستحقه ولو بعد حين، الذي يعرف نقاط ضعفنا، وقوتنا أكثر من أنفسنا، واكتشفوا أنفسكم، ولا تُلهيكم التوافه، والمُغريات عن أنفسكم، وحقيقة وجودنا على هذه الأرض. حاولوا كثيرًا ولا تستسلموا؛ فقد يكون القبول في تخصصٍ ما طريقًا أراد الله لكم عبوره كي تصلون لتخصصٍ آخر -لحكمةٍ بالغة- وتقبّلوا الأمور التي فُرضت عليكم، وتعايشوا معها سيُصبح مرورها أسهل بكثير، فغالبًا تكون مشكلتنا ليست في الأمور التي فُرضت علينا؛ بل في رفض تقبّلها والتعايش معها. عدم تقبّلك لن يُفيدك، ويُغيّر شيئًا إن لم يكن بيدك حيلة؛ فاستمتعوا ما دمتم مُجبرون.
• أسأل الله قرة أعين السائلين.. أن يجود عليكم بكرمه، ورحمته طمأنينةٍ تستقرّ في قلوبكم لا يبدّلها قلق، ولا يؤرقها هم، وأن تُرفرف أجنحتكم في سماءِ أحلامكم، ويكتب لكم الخير حيثما كان ثم يرضيكم به، إنَّك سميع الدعاء. 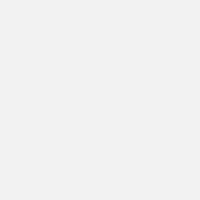
سوانح سارة