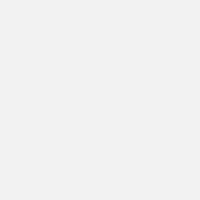المسافر

"لا تلوّح للمسافر.. المسافر راح
ولا تنادي للمسافر.. المسافر راح"
بدر بن عبد المحسن قال عن قصيدته (المسافر): "كانوا الناس يحجزون للرجعة لمّا تبدأ المدارس ففجأة تفضى باريس، ولمّا تجلس أنت تلاحظ الفرق! مب إنك تفقد واحد ولا اثنين.. تفقد ناس كثير، ويمكن ما تعرفهم بس تحس بوحشة، إحساس الوحشة هو اللي ولّد المسافر"
أتأمّل كل من يلوّح بيده؛ لتوديع أحبابه كم كلّف نفسه فوق طاقتها مع كل تلويحة وداع، وكم طلبت كفّه الالتفات للمرّة الأخيرة، أو ربما ليست الأخيرة؛ بل الالتفات للأبد حيث لا وداع أبدًا…مثلما قال طلال الرشيد:"ليت ربي ما كتب لحظة وداع"
ولأني محبّة للتأمل، فالمطار يُتيح لي الانغماس به، فأدع نفسي هكذا إلى أن أسمع نداء الرحلة، ودائمًا أترك رسائل في المقاعد، مقعد الجامعة، مقعد المطار، مقعد المقهى… فتركتُ ذات مرة رسالة في أحد مقاعد المطار، وكان نصّها:
"أهلًا.. ربما ستضحك قليلًا لأنني أحمل قلم، ودفتر في المطار بين كل هذه الحقائب، لكنني أحمله دائمًا لسببٍ قد أعرفه وقد أجهله -وهو كما يحدث الآن- لم أُخطط لكتابة رسالة لك لكنني أكتب الآن بهدوء.. رغم كل ما يحمله المطار من قلقٍ، بين ضجيج الناس، وأرقام الرحلات، والتمنيات برحلة سعيدة، والإنذار بالتنبيه الأخير، وسيُثير استغرابك كتابتي رسالة لأحدٍ لا أعرفه؛ لكنني لم أهتم يومًا بهذا الأمر، وربما هذا من سوء حظك؛ لكوني ثرثارة قليلًا. لا أعرف إن كنت ذاهب وتحمل قلق الذهاب كحقيبةٍ على ظهرك، أو عائد ولا تشعر بقدميك على الأرض لشدّة البهجة -وذلك ما أرجوه- لأن "كم تجعل الفرحة والسعادة الإنسان جميلًا" وأعتذر عن سوء خطي. لكنني، وأخيرًا سأنهي ثرثرتي بسؤالٍ قد يُثير اهتمامك؛ نحو ماذا تشعر بالامتنان؟ ليس بالضرورة أن أعرف الجواب، يكفيني أن يوقظ غفلتك عمَّ يجب لك الامتنان تجاهه."
ولطالما أطلتُ النظر في ساحة المطار.. الفرح، والحزن يتعاركان لا أدري أيًّا منهما سينتصر! أتأمّل هذا التضاد في مكانٍ واحد، وآنٍ واحد، أتهجّى كفوف الملوّحين؛ لتوديع أحبتهم، وكفوف المستقبلين للأحبّة. أتأمّل وجوه المسافرين حين تعلو محياهم ابتسامة لطيفة تتوارى الأكدار خلفها، وحماس المستقبلين الذين كادوا الطيران بهجةً، وشوقًا فيخفون ذلك بالتشبُّث أرضًا.
أُتأمّل مشهد عائلة تعتريهم الهموم، وتساورهم الغموم؛ لتوديع شخصين، فشدّني بأن أصغرهم، وأكبرهم يلوّحون بأيديهم، حتى الطفل الذي لا أظنه بلغ من العمر ٦ سنوات! أتأمّل التي بجانبي وهي تراقب مرور الساعة، وتحسب الدقائق للحظة التلاقي، أتأمّل من لم يهدأ له بال، ولا رف له جفن للجلوس والانتظار، فيمشي مسافات طويلة راجيًا أن يدهس المسافة اللي تحول بينه، وبين أحبّته، ومن أنهكه الانتظار، فيغفو على المقعد وتعروه فزّةً خشية من أن يفوته الوقت، ومن يقضي وقته بقراءة كتاب، ثم يغلقه بُرهة من الزمن؛ ليتذكر لحظة التلاقي فيغدو مبتهجًا، تعلو محياه الابتسامة، فيعود لقراءته مجددًا ببهجةٍ مختلفة، ومن ينتظر عند بوابة الاستقبال فيفزّ فزة حمامة عند رؤية الأحبّة.
لطالما أسرتني لحظة الاجتماع، تلك اللحظة التي تُشرق الوجوه بالتلاقي، وتقرّ عين المسافر بالإيابِ، وتلمع أعين المستقبلين بالشوقِ، اللحظة التي لا يكون فيها سِوى مشاعر انفعاليّة.. اللحظة التي تتلامس فيها الأكف فتكون كما وصفها جبران خليل جبران:"فأحسَست عند ملامسة الأكف بعاطفة غريبة جديدة أشبه شيء بالفكر الشعري عند ابتداء تكوينه في مخيِّلة الكاتب"
وفي إذاعة ثمانية حلقة بعنوان: "عندما سكنتُ في المطار ٢٢ يومًا" وهي من أمتع الحلقات، تدعوك لتُعيد النظر ببعض الأمور.. فيقول فيها محمد المطيري: "الحياة في المطار، هي أكثر حياة متجددة، وكان المطار يوفر لي مساحة من التفريغ، أتأمّل الناس، وأكتب كل المشاهد اللي كنت أشوفها" وذكر فيها مشاهد عديدة أطال النظر فيها، تأثر وبكى، ابتهج وضحك، تأمّل وراقب…
وعند الختام، بذات القصيدة التي بدأتها:
"يالله يا قلبي تعبنا من الوقوف
ما بقى بالليل نجمة، ولا طيوف!
ذبلت أنوار الشوارع، وانطفى ضي الحروف…
يالله يا قلبي سرينا ضاقت الدنيا علينا
القطار، وفاتنا
والمسافر، راح.."